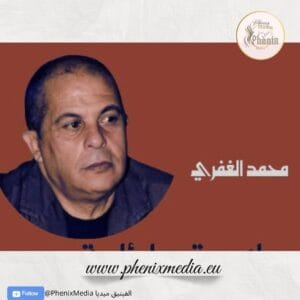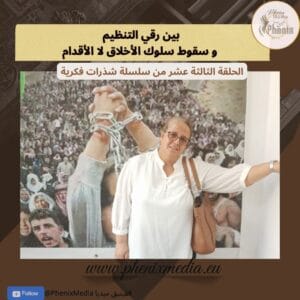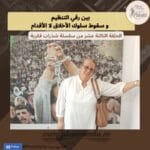العمى والذاكرة في رواية المغاربة لعبد الكريم جويطي: دراسة رمزية في الهوية والتاريخ
بقلم ذ. محمد السميري
تُعدّ رواية المغاربة لعبد الكريم جويطي واحدة من أبرز الأعمال السردية المغربية التي واجهت سؤال الذاكرة والهوية في مرحلة ما بعد الاستقلال، عبر لغة شعرية كثيفة واستعارات عميقة تنفذ إلى جوهر التجربة المغربية المعاصرة. إنها رواية عن العمى، لا بمعناه الحسي فحسب، بل كحالة رمزية تحكم الوعي الفردي والجماعي للمغاربة الذين عاشوا تواريخ متعاقبة من الخيبات والانكسارات، حتى صار فقدان الرؤية سمة وجودية للأمة.
يبدأ النص من حكاية رجلٍ أعمى يسير في مدينة فقدت بدورها ملامحها، في إشارة واضحة إلى أن العمى الجسدي ليس سوى انعكاس لعمى آخر أوسع: عمى الوعي والذاكرة. يقول السارد: «لم يعد يرى شيئًا، لكن العمى لم يبدأ حين أُطفئت عيناه، بل منذ زمن بعيد، منذ أن كفّ عن الحلم» (جويطي، 2016، ص. 14). هذا المقطع يؤسس لفلسفة الرواية كلها؛ فالمغاربة، في تصور جويطي، لم يفقدوا فقط القدرة على النظر، بل على الحلم أيضًا، أي القدرة على إعادة تخيّل ذواتهم بعد الاستقلال. وهكذا يتحول العمى إلى استعارة كبرى للوجود المغربي: عجز عن الرؤية، عن التذكر، وعن الفعل.
من خلال شخصية الأعمى، تتجسد المأساة الفردية كمرآة للكارثة الجماعية. فالرجل الذي فقد بصره نتيجة صدمةٍ غامضة يصبح رمزًا لإنسان مغربي محطَّم عاش التحولات السياسية والاجتماعية دون أن يمتلك أدوات الفهم أو المقاومة. غير أن الرواية لا تكتفي بتصوير الضحية، بل تضع بجانبه شخصية “العسكري”، الذي يمثل الوجه الآخر للمأساة: الفاعل الذي مارس الطاعة والعنف باسم الوطن، ليكتشف في شيخوخته أنه خدم وهمًا أكبر منه. حين يقول العسكري لصاحبه الأعمى: «نفّذتُ الأوامر لأنني لم أكن أرى أبعد من الحذاء الذي أمامي» (جويطي، 2016، ص. 102)، فإن جويطي يعيد إنتاج ثنائية الجلاد والضحية في صيغةٍ وجودية لا تفصل بينهما، إذ كلاهما أعمى: أحدهما عمى البصر، والآخر عمى الضمير. ومن هنا يتحول الحوار بين الأعمى والعسكري إلى مواجهةٍ بين وعيين معطوبين، يتجسّد من خلالهما التاريخ المغربي بكل تناقضاته.
في خلفية هذه الشخصيات، يحضر المكان ككائن حيٍّ متألم. مدينة بني ملال، التي تبدو في البداية فضاءً محليًا محدودًا، تنفتح تدريجيًا لتصبح صورة مصغّرة للمغرب نفسه. تتحدث الرواية عن مدينة «تتآكل من الداخل مثل جسدٍ أصيب بسرطان اللامبالاة» (جويطي، 2016، ص. 57). الشوارع المهترئة، المشاريع العقارية التي تلتهم الأرض، المقابر التي تُهدم، كلها علامات على تفسّخ عمراني وأخلاقي متوازٍ. المكان في المغاربة ليس خلفية محايدة للأحداث، بل ذاكرة حية تختزن وجع الأجيال، وكأن كل بيتٍ أو حقل أو مقبرة يحمل أثرًا من قصة نُسيت. بهذا المعنى، تتحول بني ملال إلى استعارة عن الوطن المنسي الذي أُعيد تشكيله وفق منطق السوق والسلطة، لا وفق منطق الذاكرة والانتماء.
ولعلّ المقبرة هي المكان الأكثر كثافة رمزية في الرواية. فهي ليست موضع موتى فقط، بل موضع ذاكرة تُمحى. حين يصل الأعمى والعسكري إلى المقبرة في نهاية الرحلة ويجدانها قيد الهدم لإقامة مشروعٍ عمراني، يتجلّى المشهد كذروة مأساة الرواية: الماضي يُقتلع ماديًا، كما اقتُلع معنويًا من الوعي الجماعي. يقول السارد: «حتى المقابر لم تعد آمنة من الحفر والبيع، صاروا يبيعون الذاكرة بالمتر المربع» (جويطي، 2016، ص. 186). هنا يبلغ الرمز أقصاه؛ فهدم المقبرة يعني محو التاريخ، ونسيان الموتى يعني فقدان صلة الأحياء بأنفسهم. ومع ذلك ، تصبح المقبرة المكان الوحيد الذي “يرى” فيه الأعمى، لأن الظلام الخارجي يقوده إلى بصيرة داخلية: «في المقبرة رأيتُ كل شيء، رأيتُ ما لم أرَه حين كنتُ أُبصر» (جويطي، 2016، ص. 190). هذا التحوّل يُبرز أن الرؤية الحقيقية في الرواية لا تأتي من العين، بل من الذاكرة والألم، أي من القدرة على مواجهة الموت بوصفه مرآة للحياة.
من خلال هذا التوازي بين العمى والمقبرة والمكان، يبني جويطي سردًا معقدًا يتجاوز الواقعية المباشرة إلى تخوم الرمزية الفلسفية. فالأعمى والعسكري ليسا مجرد شخصيتين، بل صوتان متقابلان في وجدان جماعي واحد، كلاهما يحمل ملامح المغرب المتعب من تاريخه. أما المدينة والمقبرة، فهما فضاءان يتحركان بين الواقعي والمتخيل، بين الحياة والموت، ليعبّرا عن تلاشي الحدود بين الفرد والوطن، بين الذاكرة والنسيان.
ويكتمل المعنى حين نعود إلى العنوان نفسه: المغاربة. اختيار الجمع هنا ليس لغويًا فحسب، بل دلاليٌّ عميق. فالرواية لا تتحدث عن “مغربيٍّ” واحد، بل عن مجموعٍ من الذوات الممزقة التي تشكل معًا صورة الوطن. العنوان يشير إلى جماعة فقدت وحدتها، إذ لم تعد الهوية المغربية موحّدة، بل مفككة إلى طبقات من الوعي والخذلان. يكتب جويطي: «المغاربة ينامون في التاريخ كما ينام الموتى في المقابر، لا أحد منهم يريد أن يُوقظ الآخر» (جويطي، 2016، ص. 212). إنها جملة تلخص روح النص كلها: المغاربة أحياء بأجسادهم، موتى بذاكرتهم، يتشاركون العمى ذاته وإن اختلفت وجوهه. وهنا تنقلب الرواية من حكاية أفراد إلى مرثية جماعية لأمةٍ بكاملها.
أسلوب جويطي في هذا العمل يقوم على تكسير البنية الزمنية، وتداخل الأصوات السردية، واستعمال لغة تتراوح بين النثر الشعري والتوثيق التاريخي. لا يقدّم الحدث بطريقة خطية، بل في مقاطع متقطعة تشبه ومضات الذاكرة، مما يعكس تفتّت الوعي الجماعي الذي يصوره. اللغة بدورها تتوزع بين الفصحى التأملية والحوار الشعبي المضمّن، مما يمنح الرواية ملمحًا هجينيًا يعبّر عن تعدد الأصوات داخل المجتمع المغربي نفسه. هذه التقنية تجعل من المغاربة نصًا مفتوحًا، يمكن قراءته سياسيًا وتاريخيًا وفلسفيًا في آنٍ واحد.
إن رواية المغاربة ليست فقط عملاً أدبيًا عن زمنٍ مضى، بل نصًّا عن الزمن المغربي بوصفه جرحًا دائمًا. في نهاية الرواية، حين يقف الأعمى والعسكري أمام المقبرة المهدَّدة بالزوال، لا نجد خلاصًا ولا أملًا، بل وعيًا بالهزيمة وبالحاجة إلى الرؤية: «لم يبق لنا إلا أن نفتح أعيننا، ولو على الخراب» (جويطي، 2016، ص. 219). إنها خاتمة تؤكد أن طريق النهوض يبدأ من النظر إلى الظلام، لا من الهروب منه. فالمغاربة، كما يريد جويطي أن يقول، لن يُبصروا النور إلا حين يعترفوا بعمى ذواتهم، حين ينبشوا مقابرهم الرمزية ليستعيدوا ذاكرتهم، لأن الأمم لا تموت إلا حين تنسى.
المراجع:
• جويطي، عبد الكريم. (2016). المغاربة. الدار: دار إفريقيا الشرق.
• بلقاسمي، سعيد. (2018). “العمى والذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة”. مجلة الدراسات الأدبية المغربية، 12(3)، 45-62.
• الغزالي، فاطمة. (2019). “رمزية المكان والمقابر في رواية جويطي المغاربة”. الدار البيضاء: مركز النشر الجامعي