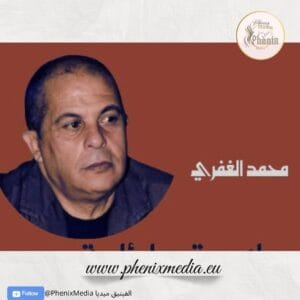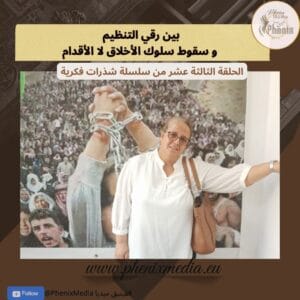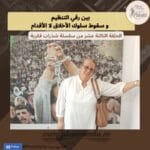أزمة النخب الحزبية في المغرب: قراءة بنيوية تاريخية في الأحزاب الكبرى
بقلم ذ. محمد السميري
تُعتبر النخب الحزبية في المغرب الركيزة الأساسية لاستقرار الحياة السياسية، ومن المفترض أن تؤدي دورًا محوريًا في صياغة المشروع المجتمعي وبناء الديمقراطية الحديثة. غير أن التجربة الحزبية المغربية، وبالأخص الأحزاب الكبرى التي خرجت من رحم الحركة الوطنية، تكشف عن أزمة بنيوية عميقة، تتجاوز مجرد ضعف التنظيم أو قصور القيادة، لتصل إلى جذور تاريخية وثقافية مترسخة في تكوين هذه الأحزاب منذ نشأتها. فقد أسست هذه الأحزاب، بما في ذلك حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على قيادات تاريخية مرتبطة بالمسار الوطني المغربي، وهو ما رسّخ نمط قيادة مركزية وشخصية، قلّص من قدرة هذه الأحزاب على تطوير مشروع فكري وسياسي متجدد، وخلق حالة من الجمود التنظيمي والسياسي انعكست على برامجها وممارساتها ([خروبي بزارة، 2021، ص. 45-78]).
يشير محمد الزاهي في تحليله للفضاء السياسي المغربي إلى أن الدور التاريخي للزوايا كفضاءات للسلطة الرمزية والاجتماعية ساهم في ترسيخ ثقافة القيادة الفردية داخل الأحزاب الحديثة. فالنمط التقليدي للقيادة، المرتبط بالتحالفات التاريخية والولاءات المحلية، يمنع تداول السلطة داخليًا ويؤثر سلبًا على قدرة هذه الأحزاب على التفاعل مع التحولات المعاصرة، سواء على المستوى الفكري أو المؤسسي. وقد انعكس هذا النمط على ديناميات الأحزاب، حيث ظلت الولاءات الشخصية والتحالفات الداخلية محددات أساسية للقرار السياسي، على حساب الكفاءة والتجديد، وهو ما يفسر استمرار القيادة الحالية لفترات طويلة دون أن تتبنى هذه الأحزاب مشاريع إصلاحية استراتيجية قادرة على تلبية تطلعات المجتمع المغربي ([الزاهي، 2011، ص. 112-150]).
من جهته، يؤكد أحمد حمودي أن الأزمة التي تعانيها الأحزاب المغربية ليست أزمة أشخاص فحسب، بل أزمة مشروع. فغياب التجديد والتحديث البنيوي يعكس عدم قدرة هذه الأحزاب على تمثيل مصالح المواطنين، خصوصًا الشباب، الذين يبتعدون عن المشاركة السياسية بسبب شعورهم بأن القرارات الحزبية محصورة في دائرة ضيقة من القيادات التقليدية. كما يرتبط هذا الوضع بعدم ملاءمة النخب الحزبية للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ما يؤدي إلى تراجع الفعل التأطيري للأحزاب وفقدانها لشرعية تمثيل المجتمع ([حمودي، ص. 60-102]).
عند النظر إلى التركيب البنيوي التاريخي للأحزاب المغربية الكبرى، يمكن ملاحظة أن هذه الأزمة ليست حادثة معاصرة، بل امتداد للإرث التاريخي للحركة الوطنية، حيث رسّخ الانخراط في العمل السياسي المبكر اعتماد قيادة مركزية تقليدية تعتمد على الولاءات الشخصية والتحالفات الرمزية، وهو ما أعاق تطوير ثقافة تنظيمية ديمقراطية داخل الأحزاب. هذا الإرث البنيوي يوضح لماذا تظل هذه الأحزاب عاجزة عن طرح مشروع مجتمعي متكامل ومؤثر، ويفسر استمرار فجوة الثقة بين النخب والمجتمع، خصوصًا بين الفئات الشابة التي لم تعد تجد في الأحزاب إطارًا يعكس تطلعاتها وأولوياتها في هذا السياق، تظهر ظاهرة الزعامة الفردية في الأحزاب الكبرى، بما فيها حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، كأحد أبرز ملامح الأزمة البنيوية، حيث يتركز القرار في أيدي قيادات تاريخية، ويُحد من تداول السلطة والتجديد الداخلي. وهذه الظاهرة تؤكد أن الأزمة ليست فردية أو مرتبطة بحزب واحد، بل هي سمة عامة للفضاء الحزبي المغربي.
علاوة على ذلك، يمكن المقارنة بين مفهوم الحزب في الأنظمة الديمقراطية وموقع الأحزاب المغربية ضمن النظام السياسي الوطني. في الديمقراطيات الحديثة، يُنظر إلى الحزب كمؤسسة منظمة قائمة على التداول الداخلي للسلطة، تحديد البرامج السياسية بشكل تشاركي، وتمثيل مصالح المجتمع بمختلف فئاته، مع ضمان مشاركة النخب وتدريبها على ممارسة القيادة وفق قواعد شفافة. بالمقابل، يفتقد النظام السياسي المغربي لهذا المفهوم المؤسسي المتكامل للحزب. فغياب إطار مؤسسي ديمقراطي كامل، ووجود نظام سياسي هجين، يصعّب تأسيس أحزاب حديثة ضمن بنية تقليدية، ويؤدي إلى هيمنة الزعامة التاريخية على القرار السياسي، وهو ما يعزز أزمة النخب الحزبية ويحد من قدرة الأحزاب على تطوير مشروع فكري وسياسي متجدد ([خروبي بزارة، 2021، ص. 67-70]).
و يشير وتربوري بهذا الصدد في كتابه أمير المؤمنين إلى أن طبيعة النظام السياسي المغربي التقليدي، يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تطور الأحزاب الحديثة، إذ يحد من قدرة الأحزاب على تأسيس مؤسسات حزبية فعالة ومستقلة ([لوتربوري، 2000، ص. 78-85]).
الخاتمة
إن أزمة الأحزاب المغربية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، ليست مجرد أزمة قيادة شخصية أو تنظيمية، بل هي انعكاس لأزمة مشروع شاملة، تتعلق بتاريخ هذه الأحزاب، تركيبها المؤسسي، وطبيعة ثقافة القيادة التي ورثتها من الحركة الوطنية. وتزيد هذه الأزمة تعقيدًا طبيعة النظام السياسي المغربي نفسه، الذي لا هو بالتقليدي ولا هو بالحداثي، إذ يخلق إطارًا هجينًا صعبًا على الأحزاب أن تتشكل وفق نموذج حديث يعتمد على التداول الداخلي للسلطة والمؤسساتية الديمقراطية، بعيدًا عن نمط الزعامة الفردية. ونتيجة لذلك، تستمر الأحزاب الكبرى في إعادة إنتاج القيادة التقليدية والولاءات الشخصية، وهو ما يحد من قدرتها على تطوير مشاريع سياسية وفكرية متجددة قادرة على تمثيل المجتمع بشكل فعال ومستدام ([الزاهي، 2011، ص. 140-145]; [حمودي، ص. 95-102]; [وتربوري، 2000، ص. 78-85]).
ومعالجة هذه الأزمة تتطلب إعادة تفكيك الإرث البنيوي للحزب، تطوير آليات تداول السلطة داخليًا، صياغة مشروع فكري وسياسي متكامل قادر على استعادة الثقة الشعبية، وفتح المجال أمام دمقرطة العمليات الداخلية. هذا النهج هو السبيل الوحيد لضمان استعادة الأحزاب المغربية لدورها كممثل حقيقي للمجتمع، ولتجاوز الجمود التاريخي والسياسي الذي يعيق التجديد والابتكار في المشهد الحزبي.
______________
المراجع:
- خروبي بزارة، عمر. أزمة الفكر السياسي والمشروع المجتمعي للنخب الحزبية في المغرب العربي. ص. 45-78.
- الزاهي، محمد. الزاوية والحزب: الإسلام والسياسة في المجتمع المغربي. ص. 112-150.
- حمودي، أحمد. دراسات حول النخب الحزبية المغربية، ص. 60-102.
- وتربوري، أمير المؤمنين. ص. 78-85.