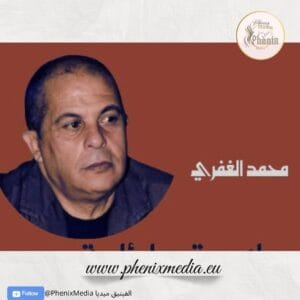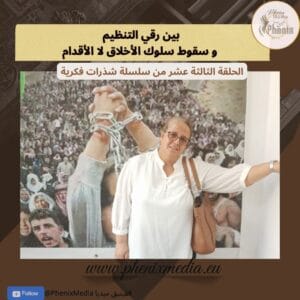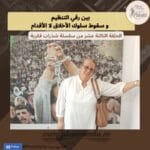الاحتجاج والمقاومة في تاريخ المغرب
ما بين 1860 – 1612
الكاتب : ادمون بورك
ترجمة الأستاذ محمد أعفيف.
تقديم و قراءة: علال بنور/المغرب
لا يختلف عاقلان في القول، أن كل تقديم لإنتاج تاريخي هو محاولة استكشافية جديدة لمنعطفات الكتاب من طرف القارئ الباحث، لذلك، فإن هذه العملية تقتضي القراءة المتأنية، مع طرح أسئلة وملاحظات لإشراك القارئ الكريم فيما انتبه إليه مؤرخ المنتوج التاريخي وقارئه. في هذا الإطار، سعيت إلى تقديم هذا الكتاب لثلاثة اسباب، الأول لأهمية الكتاب الذي استغرق فيه “ادموند بروك ” عشر سنوات من البحث فقدمه رسالة دكتوراه بجامعة “برينستون” والسبب الثاني، أن الأستاذ المترجم محمد أعفيف له كفاءة ودراية عالية باللغة الإنجليزية والفرنسية التي ترجم منها الكتاب. سي محمد أعفيف مؤرخ وعالم انثروبولوجيا لذلك، نجده في كتاباته التاريخية يجمع بين المنهج التاريخي والتصور الانثروبولوجي، ثالثا، فهو أستاذي في مرحلة الدراسات الجامعية، حيث أخذت منه الكثير. واليوم اتتبع انتاجاته التاريخية. هل تدخل ترجمة الكتاب ضمن مطلب استاذنا إبراهيم بوطالب في دعوة طلبته بالاهتمام بترجمة المنتوج التاريخي الكولونيالي كخطوة أساسية في كتابة تاريخ المغرب؟ عكس التيار الوطني الذي رفض التعامل مع الكتابات الاستعمارية في حدود الرد عليها وتصحيحها فقط.
هندسة الكتاب:
وجدت كتاب “الاحتجاج والمقاومة في مغرب ما قبل الاستعمار (1860 – 1912)” مغريا للقراءة من خلال عنوانه، ونحن في قراءاتنا للمصنفات التاريخية، اعتدنا أن نربط غالبا الاحتجاج والمقاومة بالاستعمار، لكن هذا العمل التاريخ، يربطهما بالمخزن والصراعات المتعددة الأطرف: الصراع بين المخزن والقبائل من جهة وبينه والطامحين من الثوار في السلطة وأحيانا الصراع مع القواد الكبار، ومرة أخرى بين المخزن والفقهاء والزوايا، ومن هنا يأتي إغراء قراءة هذا الكتاب.
أعود إلى القول، أن اختياري لتقديم هذا الكتاب يرجع الى عدة اعتبارات: أهمها مصداقية ومهارة وعلمية الترجمة عند استاذنا محمد أعفيف المتمكن من التعريب من اللغتين الفرنسية والانجليزية إلى اللغة العربية، ثانيا القيمة العلمية التاريخية عند صاحب الكتاب السيد” ادموند بورك “. يقع الكتاب في 360 صفحة من الحجم الكبير يبتدئ بمقدمة الترجمة من تقديم الكاتب نفسه، يوضح فيها موقفه من الكتابة الكولونيالية حول المغرب، كما طرح فيها صعوبات الحصول على مصادر عربية وارشيفاتها. يلي هذه المقدمة كرونولوجيا الأحداث التي تغطي الكتاب بالكامل، لمساعدة القارئ في ضبط الأحداث بسنواتها.
يليها مقدمة ثانية للكاتب ذاته، متجاوزا المقدمات الكلاسيكية التي تعتمد على تلاخيص الفصول إلى شرح وتوضيح القضايا الكبرى التي يتناولها الكتاب، حيث وقف عند المناخ العام الذي عرفه المغرب في الفترة المدروسة والممتدة من 1860 إلى 1912. موضحا اختلاف المغرب عن الدول العربية في نظام الحكم ثم علاقة المغرب باوربا.
يتضمن الكتاب 9 فصول، كل فصل يحتوي العديد من العناوين، أصل لغة الكتاب، هي الإنجليزية. صدرعن جامعة شيكاغو بريس وعن لندن سنة 1976، ترجم إلى العربية في طبعتين الأولى 2013 والثانية 2025 عن منشورات كلية الآداب بالرباط.
اضاءات حول الكتاب:
للكتاب أهمية علمية، نرصدها من خلال تنوع مصادره المطبوعة، سواء لاتينية أو عربية، بالرغم من الصعوبات التي وجدها الباحث عند طلبه الولوج إلى الأرشيفات المخزنية. كما تكمن في شخصية استاذنا محمد أعفيف الذي لا يقدم على أي عمل إلا إذا كان يتسم بالجدية، وهو المترجم المحنك بإتقانه اللغة الفرنسية والانجليزية كما ذكرنا سابقا. فالكتاب عبارة عن أنماط التغيرات وعملياتها المعقدة بغاية تسليط الضوء على أزمة النظام المخزني في المغرب، والذي يسميه الكاتب ب “النظام القديم في المغرب”. ارتكز هذا العمل على مصادر مختلفة، المنشورة وغير المنشورة التي بقي بعضها بكرا في الأرشيفات الأوربية، باستثناء الأرشيفات المغربية التي يقر بها الكاتب، أنه وجد صعوبات في الولوج إليها. في الوقت الذي كان فيه الباحث المؤرخ المغربي ناصبا كل اهتمامه حول التأريخ للحركة الوطنية. لم يعطي أهمية لموضوع الاحتجاج والمقاومة بين مكونات المغرب خلال أواخر القرن 19م، والتي يمكن أن يفسر بها الحركة الوطنية خلال القرن 20م.
كان المؤرخ المغربي، يعتبر حركات الاحتجاج والمقاومة في مغرب ما قبل الاستعمار- يقول المؤلف – مجرد حركات خالية من أي مغزى سياسي، بل هي مجرد فوضى ومظهر من مظاهر التعصب ضد الأجانب. ويعلن الكاتب عن رأيه حول هذه القضية، حيث ينظر إلى أن المقاومة والاحتجاج ما قبل الاستعمار هي في الأصل حركات وطنية ضد المخزن. معتبرا أن الحركة الوطنية التي انطلقت مع 1912 بقيادة النخبة البدوية والحضرية، هي امتداد للحركة الوطنية خلال القرن 19، والتي قادها سكان البوادي.
كانت الكتابات التاريخية الاستعمارية محط خلاف ونقد بين المؤرخين المغاربة فيما بينهم وبين الأجانب، أما وجهة نظر المؤرخ ” ادموند بروك” في هذا الموضوع، يعتبر أن كل المصادر تعكس الظروف والحيثيات التي نشأت فيها. لذلك يدعو المؤرخين، الاعتماد على مصادر متنوعة تقريبا للموضوعية. كما اعتمد هو في هذه الدراسة التي تعد جزءا من أطروحة الدكتوراه، يقر أنه كان حذرا في تعامله مع المصادر الأجنبية التي تتسم بتحيز واضح، ولم يستغن عنها.
في العودة إلى طروحاته التي دافع عنها في احداث تاريخ المغرب، أحيانا نجده يعقد مقارنة بين المغرب وباقي دول شمال افريقيا، بل يسير به بعد النظر إلى ما سماه بالدول العربية الإسلامية بالشرق العربي أنها تتقاطع في بعض الجوانب، منها طلب القروض من الأبناك الأوربية بفوائد قاسية لتمويل مشاريع الإصلاح الكبرى، وعندما وجد المغربة صعوبة في تأدية الديون قبل بمراقبة الأبناك الأوربية لماليتها. وندرج هنا مثالا: قرض 64 مليون فرنك فرنسي الذي حصل عليه المغرب سنة1904 والذي كان له أثر خطير على الخيارات المتاحة للمخزن المغربي. وهناك إشارة، لا يجب أن نفوتها، أكد عليها الكاتب، وهي أن المغرب، كان الأكثر مأساوية في المنطقة منذ أن بدأت الهوة الاجتماعية تتعمق بين الفقراء والأغنياء سنة 1900.
نجد الكاتب / المؤرخ عالج قضية الاحتجاج والمقاومة في بعدها الشمولي في المغرب، وارتباطا بذلك، أخذت الأزمة الاقتصادية تتفاقم، فتعاظمت معها حدة التوتر الاجتماعي بين عموم المغاربة وذوي الامتيازات الذين ارتبطت مصالحهم بالأوربيين. أما على مستوى الانتفاضات، وبعضها تطور إلى ثورات رصدها الكاتب في البوادي والمدن، مبعدا عنها الدافع الاقتصادي والفقر إلى دافع ديني. ولا ندري لماذا هذا الاختزال في الجانب الديني؟ في الوقت الذي يشير فيه، أنه يتبنى التيار التاريخي الاجتماعي.
يطرح الكاتب/ المؤرخ سؤالا يحتمل الصواب، يبدو أنه يحمل هما تاريخيا. يقول: هل أشرت هذه الفترة موضوع الدراسة على نهاية النظام القديم (وهنا يقصد النظام المخزني) أم أشرت على بداية المغرب الحديث؟ يجيب عن هذا السؤال بالقول: يمكن القول إنها أشرت بطرق شتى على الاتجاهين معا. ثم ينتقل إلى الحديث عن موقف النخبة القروية /البدوية والنخبة الحضرية من السياسة الفرنسية خلال سنة عقد الحماية 1912، التي أصبحت أكثر عنفا، فقلقها انتهى إلى اختيار المقاومة.
إذا كانت انتفاضة 1912 قد شكلت عرقلت الانطلاقة الفعلية للحماية الفرنسية على المدى القصير، فإنها وضعت على المدى البعيد، الأسس التي انطلق منها الجنرال ليوطي في مقاومة الثورة. وافقت النخب المغربية في النهاية على دعم الحماية الفرنسية ما دام أنها لا تمس امتيازاتها. على ذلك الأساس، طبق ليوطي السياسة ” الناعمة” لصرف انتباه النخب عن استيلاء الفرنسيين على خيرات المغرب.
يقر الكاتب، أن المغرب، دولة عميقة الجدور التاريخية مقارنة مع باقي دول شمال افريقيا، فهو من الدول القليلة التي حافظت على استقلالها. وفي مستوى آخر يشير، على أن العامل الوحيد – ولو أن التاريخ لا يؤمن بأحادية العامل – الذي مكن المغرب من تجاوز وضعية الجزائر التي احتلتها فرنسا سنة 1930، هو الدعم الدبلوماسي لبريطانيا في قضية الإصلاحات طيلة القرن 19م، والتي ولدت مشلولة. لذلك فإن التحالف الأوربي ضد المغرب – الذي اعتبروه أرنبا يجب توزيعه – لم يفرض نفسه بصورة قوية إلا مع سنة 1900.
عرف المغرب خلال الفترة الممتدة من 1860 إلى 1912 ، والتي هي زمن هذه الدراسة، مجموعة من التحولات .الاولى هي الدخول المكثف للرساميل الأوربية إلى المغرب والتي دمرت البنيات التقليدية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مشوه .والثانية تمثلت في جهود التحديث التي ظهرت سلبياتها في تقويض البنيات الإدارية المخزنية، بل حافظت على جزء منها، والمجموعة الثالثة، تمثلت في وضع الآليات الفرنسية موضع التنفيذ منذ 1900م. يلاحظ الكاتب، أن هذه التحولات الثلاث ساهمت في انهيار المغرب القديم، الذي يقصد به المخزن وميلاد مغرب جديد حسب رأيه، وبالتالي فإن هذه التحولات – إن اعتبرناها كذلك – أدت إلى ردود فعل سياسية: الإصلاحات + المقاومة+ الثورات الشعبية + خلع السلطان عبد العزيز + عدم رضى النخبة المغربية.
يقر الكاتب، أن اهتمامه بهذا الموضوع يدخل في صلب التاريخ الاجتماعي، الذي كان من بين اهتماماته. فهذا التيار في الكتابة التاريخية المغربية سيبلوره مؤرخون مغاربة جدد، مع بداية السبعينيات، ليصل إلى مرحلة النضج مع 1975 م. اعتبر “ادموند بورك ” أن الكتابات التاريخية الكولونياليا لا زالت محط خلاف ونقد. كما أقر أنه اعتمد في انجاز مصنفه هذا على المراجع المغربية بشحها، وعلى وفرة المراجع الأجنبية المنشورة والأرشيفية الموجودة بالدوائر الأوربية المفتوحة لعموم الباحثين.
عالج الكتاب قضية الاحتجاج والمقاومة من زاويتهما الداخلية وفي بعدهما الشمولي. كما تتبع مراحل الانتفاضات في المدن والبوادي إلى غاية 1912م السنة التي فتحت الباب أمام الاحتلال الفرنسي للمغرب. هل هذه الفترة أبانت عن نهاية النظام القديم أم أشرت على بداية المغرب الحديث؟