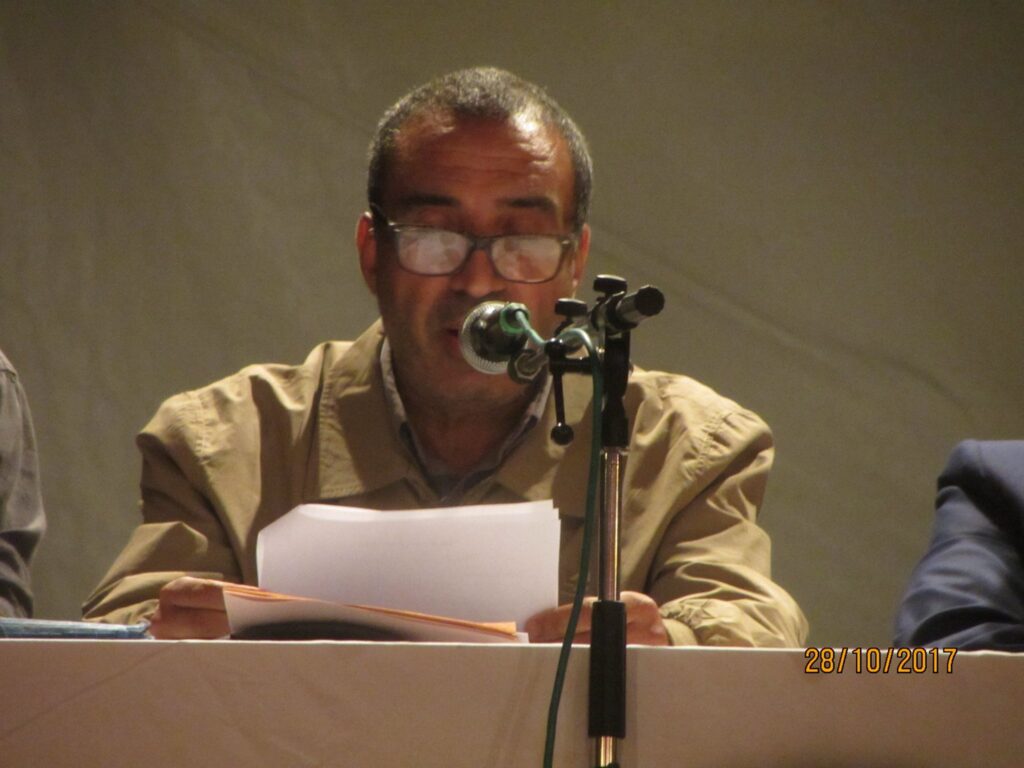حارق الضوء الأحمر
المصطفى صباني – الدار البيضاء
فتحت عيني كمن يخرج من تحت الماء ليستعيد الهواء داخل رئتيه المختنقتين في قفص الصدر، وجدتني ملقى على ظهري والقيود في يدي وقدمي تكبلني بالسرير. جلت بنظري في سقف وجدران الغرفة الصامتة والرطبة ولمحت الأزرق الداكن لسترتي الرثة، فأدركت أني داخل مشفى الأمراض النفسية والعصبية، وأني نزيل يُخشى جانبه، لا أمان لمن يقربه حين تُفك قيوده.
كل ما أتذكره من ذلك اليوم الأهوج وأنا الآن بين صحوة العقل وسكرة الحقنة المخدرة، أن يدي اليمنى كانت تقبض على مقود السيارة واليد اليسرى تضغط على البوق بعد أن طفح كيل انتظار اشتعال الضوء الأخضر. كان الزمن ينزف على عقارب الساعة وطابور السيارات يزفر زفرات حرى ولا يقوى على الانطلاق، وعمود الإشارة لا يبرق الضوء أخضر إلا ليعاود الاحمرار، صحت أسب وألعن الطريق والمدينة والشرطة والحاكمين، ولم يسلم من لعناتي إلا الرب والملائكة والرسل والصحابة أجمعين. كان الجميع منصهرا في علب الحديد يتشظي من نار احتراق الأعصاب والبنزين والسجائر، ولا يقوى على كسر ذلك العمود وإطفاء أضوائه المهينة. لا أدري متى خرجت من السيارة عاري الصدر بعد أن نزعت عني قميصي، أشعلت فيه نار سيجارتي وفتحت فوهة خزان البنزين وألقيت به في جوفه، انفجرت السيارة ورمت بحممها على كل الطابور الواقف الذي تحول بغتة إلى كتلة لهب متدحرجة، الكل خرج يقفز هاربا من علبته الحديدية، يطارده الحريق ودخانه المتصاعد، أما أنا فقد وقفت عاريا أمام عمود الإشارة الضوئية أقهقه تارة وأصرخ فيهم تارة أخرى وهم كالحمر المستنفرة فرت من قسورة: “هيا ارموا بأنفسكم في البحر، ماذا تنتظرون؟ مدينة “البيضاء” ستفرد جناحيها كالعنقاء وتنفضكم كالقمل عن ريشها وتحترق على جمر سخطها كما احترقت سنوات الدم والرصاص. اشتعلي نارا واحترقي ولا تخرسي ألسنة لهبك واقذفي بشررك كل هذه الأجساد الكابية خلف صمتها الذليل…”.
فُتحت الباب، دخلت الممرضة وخلفها الطبيب، قاست نبضي وسجلت على لوحة درجته ثم أمرها الطبيب بفك الأحزمة عن يدي وقدمي. قال الطبيب ساخرا وهو يراني أحاول النهوض دون جدوى من شدة المخدر: “لا تقلق، ستظل صحبتنا أطول مدة ممكنة حتى تصبح وديعا مثل الحمل اللصيق بأمه. شفع لك جنونك في تفادي حبس طويل المدة. لكن سجننا لن يكون أرحم من سجن القضاة، فلن تخفف مدة بقائك مهما أبليت في الانصياع، نحن سنشفيك من نفسك التي توسوس لك بارتكاب أشنع الأفعال، وسنعلمك قول نعم قبل أن تفكر في قول لا، وسوف تلتزم الصمت والرضا، ولن تفارق الابتسامة مهما بالغنا في أذية جسدك، وستستنجد بنا لغرز جسمك بكل الحقن المؤلمة كلما وخزك ضميرك الشقي، وإذا لم يطاوعك، سنخرس جنونه بالصدمات الكهربائية”، ثم نادى على ممرضين ساعداني على الوقوف. وقفت متهالكا لا أقوى على حمل نفسي في طابور من مجانين مثلي. حالما وصلت بالكاد إلى المنضدة حتى مدت لي ممرضة أقراصا بلعتها بكوب ماء، ثم ارتميت فوق كرسي كخرقة بالية. كل شيء بدا لي ثقيلا يتحرك ببطء وجسدي حزمة من الأعواد اليابسة تتناثر كلما حاولت النهوض أو السير، أما لساني فقطعة من الخشب مدسوسة في فمي كلما تفوهت تعثرت به كلماتي فتساقطت حروفا جافة. الكل فاغر فاه، منفوخ الحواصل كطيور البجع، لا يستطيع مد يديه لهش الذباب اللاعق لمسامه.
تناسخت الأيام وأنا بين قيود السرير نائم أو واقف في الطابور ألقم الأقراص، وبين الزوايا الكئيبة أقذف بجثتي أينما تسنى لي الركون. غير أن شيطاني كان يخرج من بين جوانحي سالما معافى يتفقد كل أركان النزل وحجراته ويتجول بالحديقة المطلة على الشارع العام ثم ينثر في مخيلتي كل ليلة؛ قبل سريان المخدر؛ ما التقطه سمعه وبصره من حديث وصور عالم بات بعيدا عن ملمس حواسي الذابلة. مرة أيقظني في هزيع الليل وجلس على جانب السرير واقترب من أذني هامسا: “للجدران آذان صاغية فلا ترفع صوتك. سأخرجك من محبسك لتعانق “البيضاء” المشتعلة في وشاحها الأزرق، فهي تنتظرك من وراء قضبان المشفى، تحمل بين يديها قميصك المحترق؛ تتنسم دخانه وتنثر رماده”. كساذج أبله أبلى في طاعة سيده، صرت له عبدا ينتظر مخلّصه، ظللت أترقبه كل ليلة ليلقي علي مسوح الطمأنينة والأمل. ويوما خالف موعده الليلي، جاءني صباحا، تلبّسني كما يلبس العاري عباءة واسعة، وامتطى صهوة عقلي وروحي، واقتادني كما تقاد الدابة الخرساء نحو المسلخ، ألقى بحبات الدواء تحت لساني دون أن تفطن الممرضة لخداعه وأسرع بي نحو المرحاض لألفظها وأسحب عليها الماء. صرنا جسدا واحدا تماسكت أطرافه بعد زوال وهن المخدر، يدي يده وعقلي طوع أفكاره، عروة وثقى تصلبت آصرتها في تناسخ مطبق.
اشتعلت برأسي بوارق الخلاص وأنا أجر الخطى موهما الطبيب والممرضين بدوام حالي المنكسرة. إبليس الذي يصوب فوهة فمي في آذان الحمقى مثلي، ألقى في نفوسهم جرثومة العصيان، وصرنا جميعا في موكب الضلال نمكر مع الماكرين، نحيك أحبولة الفخ وننسج خيوطها المحكمة الفتل. بعد ليلة مقمرة تُخرج الذئاب من وجارها، ضرب فريق منا طوقا على المشفى من الخارج وتكفل الفريق الآخر بتقييد الممرضين بسرير المجانين بعد أن وشحهم بالثياب الزرق الداكنة، أما أنا “حارق الضوء الأحمر” فقد أطبقت بقبضتي على عنق الطبيب حتى انسلت روحه من جسده المتساقط على البلاط.
على رصيف الطريق الرابطة بين البيضاء والرباط وقفت طالبا التوصيل من العربات العابرة أمامي وأنا في ثياب الطبيب متنكرا. شاحنة وقود ضخمة مطبوع على خزانها عبارة “إفريقيا” توقفت أمامي ونادى علي سائقها بالصعود إلى قمرته. كان الصمت ثالثنا يطيل مسافة البعد ويزرع في مخيلتي أشنع الخطط المريبة. قلت له “اليوم حر شديد”، رد علي:” الرباط أحر، شوارعها تغلي بالمظاهرات، ونقاط تفتيش كثيرة تمنع الدخول إلى وسط المدينة، سوف أعرج على طريق عكراش ومن هناك أصل إلى حسان، المكان الذي يمكن أن تنزل فيه”. أشرت له برأسي موافقا وبيدي شاكرا. ما إن اقتربنا من نهر أبي رقراق ولاحت من بعيد صومعة حسان، حتى تحرك في دمي شيطاني اللعين نافخا في روحه السامة. طلبت منه التوقف قليلا قرب مطارح عكراش لإفراغ متانتي المنتفخة. ما أن أوقف عجلات الشاحنة حتى عالجته بطعنة غادرة في الرقبة. بعدما مسحت مقعد السائق من الدم المراق، أشعلت المسجل على أغنية المشاهب “يا شراع” ورفعت صوتي معها مردد: “عذابك في السما، ما كواني ما دريت أنا، كيف تنسي، ما كواني ما دريت أنا”، وأنا أقود الشاحنة بجنون صاعدا نحو صومعة حسان لأبني معبدا لطائر الفينيق، عش نار يقذف بحممه العدوتين ويطهر النهر من ملوحة البحر الحارقة.